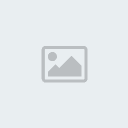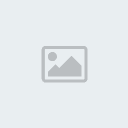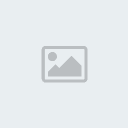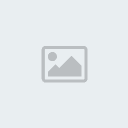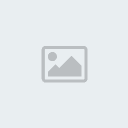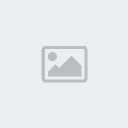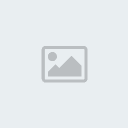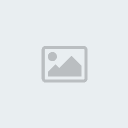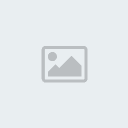توضيح ضروري..
بما أن معرفة الداء شرط ضروري لتحديد الدواء، فإنني ككاتب فلسطيني، أسير سابق ومبعد، ما زال منذ 5 حزيران 1969 يحمل في جسده شظايا من العدو (وليس من إخوته والحمد لله!) عندما قمتُ أمام الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل بطعن ثلاثة جنود إسرائيليين بسيخ كباب صنعته أيام الدراسة الإعدادية..
بما أن معرفة الداء شرط ضروري لتحديد الدواء، فإنني ككاتب فلسطيني، أسير سابق ومبعد، ما زال منذ 5 حزيران 1969 يحمل في جسده شظايا من العدو (وليس من إخوته والحمد لله!) عندما قمتُ أمام الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل بطعن ثلاثة جنود إسرائيليين بسيخ كباب صنعته أيام الدراسة الإعدادية..
وبما أنني أقول، أن هذه الشظايا التي أحملها منذ حوالي أربعة عقود، منذ كان عمري 17 عاماً، ولا زالت تؤلمني وتحرقني وأنا كهل، أقول لو كانت هذه الشظايا "من إخوتي!" لكانت تؤلمني أكثر وتحرقني أكثر..
وبما أنني مع أخوتي ورفاقي الأسرى في سجن عسقلان وغيره من السجون الإسرائيلية، كنا نضحك أكثر مما نضحك الآن، ومعنوياتنا آنذاك أعلى مما هي عليه الآن، وتوصَّلنا يا "أبطال الإقتتال" و"عشاق الكراسي" و"ملوك الفصائل" إلى درس باهظ ومرير هو: يكفينا سجن العدو، وعلينا ألا نضيف إلى أغلال العدو أغلالاً نصنعها بأيدينا..
وبما أن هناك الآن إحساس فلسطيني عام، بضروة "المصالحة الوطنية" و"التهدئة الوطنية!" و"الوحدة الوطنية"، بعدما أسلنا دمنا بما فيه الكفاية.. وفضحنا أنفسنا بما فيه الكفاية.. وخيبت الفصائل أمل شعبها بها بما فيه الكفاية.. وارتفعت أعلام الفصائل على حساب علم فلسطين لدرجة المفارقة.. وصدحت الأغاني الفصائلية على حساب النشيد الوطني لدرجة الحزن والتعاسة..
وبما أن الشعب أقوى، وأن الطفل "فارس عودة" يمتلك من الرمزية أكثر مما تملكه كل القيادات الرسمية..
وبما أن زيتون البلاد أبقى من الكراسي.. وسماء فلسطين أكبر من قمصان الفصائل..
ولأن الشعب الفلسطيني سفينة بلا قبطان..
فإنني أقدم حصتي في قراءة الوجع الفلسطيني..
ولأن الشعب الفلسطيني سفينة بلا قبطان..
فإنني أقدم حصتي في قراءة الوجع الفلسطيني..
مصيبتنا: قيادتنا!
حتى الآن، لا يوجد للشعب الفلسطيني قيادة بمستوى آلامه وآماله، بمستوى القضية والصراع. هذه المشكلة ـ المعضلة لا يمكن ولا يجوز تجاهلها، إذ ببقائها وإعادة إنتاجها، سيبقى وسيعاد إنتاج مسلسل الخيبة والتبديد للشعب الفلسطيني، ستغدو المعاناة أشد والنزيف أطول.
لم يعد خافياً أن الشعب الفلسطيني، العظيم في ثوراته وصموده وتضحياته، يعاني منذ نشوء قضيته وحتى الآن، من "مرض داخلي" هو مصيبته مع قيادته، علاوة على مصيبته مع الإحتلال. هذا المرض الذي بقي غائراً ومزمناً طوال الوقت، بات بعد الإقتتال الدامي بين "حماس" و"فتح" في غزة، كارثياً وضاغطاً وفضائحياً.
لم يعد خافياً أن الشعب الفلسطيني، العظيم في ثوراته وصموده وتضحياته، يعاني منذ نشوء قضيته وحتى الآن، من "مرض داخلي" هو مصيبته مع قيادته، علاوة على مصيبته مع الإحتلال. هذا المرض الذي بقي غائراً ومزمناً طوال الوقت، بات بعد الإقتتال الدامي بين "حماس" و"فتح" في غزة، كارثياً وضاغطاً وفضائحياً.
أثبتت مسيرة الشعب الفلسطيني أن أكلاف الفشل في "إعرف نفسك" قد طغت على متطلبات "إعرف عدوك"، وأن هذا الشعب المنكوب والمكلوم ما زال يعيش تناقضاً صارخاً بين عدالة الأهداف وقصور الوسائل، وخاصة الإختلال القيادي، ما أدى، بفعل التراكم والتكريس، إلى تدني حيوية القضية الفلسطينية، ونشوء وضع فلسطيني يمكن اختصاره على هذا النحو: شعب "يتقن" الشهادة والموت باختياره ورغماً عنه، وقيادة تعشق الكراسي والإنقسام وبيع الأوهام!
على مدار سنوات كفاحه الطويل، كان للشعب الفلسطيني زعماء وقادة بارزون، من بينهم رموز وطنية تمتعت بـ"كاريزما" أمثال: الحاج أمين الحسيني، أحمد الشقيري، ياسر عرفات، جورج حبش، الشيخ أحمد ياسين... لكن لم ينجح أي من هؤلاء الزعماء، ولم تنجح التنظيمات الفلسطينية، منفردة ومجتمعة، في توليد نهج قيادي وطني توحيدي مؤسساتي، مقابل جبهة الصهيونية المتراصة والمدعومة عالمياً.
إن منظمة التحرير الفلسطينية، التي هي بمثابة هوية ووطن معنوي، هذه المنظمة، على أهميتها، لم تكن منذ نشأتها وحتى الآن مؤسسة ناجحة تقود الشعب الفلسطيني في كفاحه الصعب والمعقد، والسبب هو أنها نجحت في أن تكون ممثلاً للشعب الفلسطيني، لكنها لم تنجح في أن تكون منظِّماً لهذا الشعب، ولهذا ظلت ممثلاً قاصراً وباهتا.
لم تفشل منظمة التحرير في الإضطلاع بالمهمة التي يفترض أن تقوم بها إلا بسبب مكوناتها، وهي بالاساس التنظيمات الفلسطيينة، التي لم تشكل طليعة مجتمعية، رغم انتشار كلمة "الطليعة" في أنظمتها الداخلية، وطغى عليها الطابع الفردي والأبوي والعشائري.
لقد شكلت منظمة التحرير بالنسبة للتنظيمات إطاراً لتقاسم المقاعد والأموال (أو لتوزيعها من قبل التنظيم المهيمن والزعيم الفرد، فتح وأبوعمار) ، هذا ما كانته المنظمة وهذا ما كان يشغل التنظيمات، ولم تكن المنظمة في ذاتها وبسبب ذوات التنظيمات وقياداتها، مؤسسة للتخطيط والنضال، مؤسسة تحصي وتنظم وتفعِّل كل إنسان فلسطيني في أربع رياح الأرض، مثلما سعت وتسعى الحركة الصهيونية إزاء كل يهودي، في فلسطين المحتلة وفي "الدياسبورا".
ثمة علاقة بين فشل القيادة الفلسطينية إزاء شعبها وفشلها إزاء إسرائيل. فهذه القيادة متخلفة عن شعبها، الذي أظهر تفوقاً على قيادته في الإحساس السياسي والأخلاقي إزاء الأهداف الوطنية، وأهمية الوحدة، ورص الصفوف أمام عدو مشترك.
أما فشل القيادة الفلسطينية أمام إسرائيل فلم يحدث إلا لأن هذه القيادة لم تحترم شعبها ولم تتسلح به، وقامت، وهي مجردة من القوة، بالتعويل على أمريكا في "الضغط" على إسرائيل أو في "إقناعها"، وهو تعويل يعبِّر إما عن غباء سياسي أو عجز قيادي أو كليهما، ولم يؤد إلا إلى المزيد من عويل الأمهات الفلسطينيات على فلذات أكبادهن وعلى بيوتهن وحياتهن المقصوفة بأسلحة أمريكية الصنع والقرار!
"الفشل الفلسطيني" أمام العدو الإسرائيلي هو في الجوهر "فشل قيادي"، نتج عن تخلف القيادة الفلسطينية ذاتها وفقر مؤهلاتها، ولم يحدث هذا الفشل لأن الشعب الفلسطيني يفتقر إلى القدرات والطاقات، فهو مشهور بالنسب العالية من التعليم ووفرة الكفاءات في صفوفه، واستعداده الهائل للمواجهة والصمود والتضحية بات تاريخيا ومعروفاً. لكن المسألة هي كيف تعاملت القيادة الفلسطينية مع قدرات وكفاءات وتضحيات الشعب الفلسطيني، وكيف استثمرتها ووظفتها.
الذي يؤلم الشعب الفلسطيني الآن أشد الألم، هو أنه واقع بين وحشية الإحتلال وتعاسة الوضع الفلسطيني. والوضع الراهن يتكشف عن حقيقة باهظة: فلسطين ما عندها كبار!
غير أن الوضع لم يكن على ما يرام في ظل الكبار. في ظل ياسر عرفات كانت هناك مشكلات عويصة، والوحدة الفلسطينية غائبة، والوضع الفلسطيني مأزوم. وفي سنواته الأخيرة كان ثمة سؤال يشغل رأس "حكيم الثورة" جورج حبش، أسس لأجله مركز أبحاث، وهو سؤال: لماذا فشلنا؟!
إبان الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006 في فلسطين، والتي جلبت "حماس" إلى السلطة، كان ثمة أمل بأن تكون هذه الإنتخابات تثقيفاً في الديمقراطية للشعب ولنخبه السياسية، وإنجازاً يبنى عليه لصالح الكيانية الفلسطينية وكرامة الإنسان الفلسطيني.
لم يتحقق هذا الأمل، و"حماس" التي توسَّم الكثيرون فيها خيراً، كي تنظف "فساد فتح" وترفع من شأن المقاومة، خيبت الآمال، فسلوكها في غزة أظهر "تفوق "السلطوية" على "الجهادية"، وقمعاً وقسوة إزاء "غير الحماسويين"، وهي سياسة إقصائية مقيتة، ليس فقط لانها لا تناسب الشعب الفلسطيني وتعاكس آلامه وآماله، بل لكونها تمثل رسوباً ذريعاً في الأخلاق السياسية والنباهة السيكولوجية، حيث تستدعي على وجه الخصوص المقولة المقيتة لأعدائنا الصهاينة: اليهود و"الغوييم" (غير اليهود)!
أما "فتح"، فقد تعمق في قيادتها فساد أخطر من الفساد المالي، هو الفساد السياسي الذي لا يزداد فيه العض على السلطة بالنواجز فحسب، بل يطلق العجز أمام الاعداء إلى مداه، ويبيع الشعب أوهاماًعلى شكل آمال، إلى درجة تطليق الهيبة والكرامة!
عندما كان "الإقتتال الحمساوي الفتحاوي" في غزة على أشده، كان الإنسان الفلسطيني المقهور، يهجس: لو كان ياسر عرفات حياً، لو كان الشيخ أحمد ياسين، أو عبد العزيز الرنتيسي حياً... لما حصل ما حصل!
في عالم تندر فيه وتختفي الرموز الكبيرة والزعماء التاريخيون والشخصيات الكاريزمية، فإن شخصاً فرداًً، أو أشخاصاً أفراداً، مهما كبر وكبروا، وحتى لو كانوا رموزاً وتاريخيين وكاريزميين لا يمكن أن يضمنوا بعد رحيلهم مستقبلاً سعيداً، استقراراً راسخاً، أمناً وأماناً، حُلما طليقاً، ورغيفاً كريماً لأممهم وشعوبهم إذا كانوا يستأثرون بكل المفاتيح، ولا يرون إلاّ أنفسهم، وإذا لم يبنوا مؤسسات، ويهيئوا غيرهم، ويتواضعوا أمام البيولوجيا، ويحترموا التوارث والتراكم، ويحترموا الحياة. في هذه الحال، يصبح الوضع مفتوحاً على كل الإحتمالات، ويغدو وارداً أن يأتي "أسوأ خلف لأفضل سلف" أو يأتي الأسؤأ الذي يجعلنا نحنُّ إلى الأقل سوءاً.
عندما يرى الجميع ما يحدث بين "سلطة رام الله" و "حماس غزة" من مناكفات ومهاترات ومهازل وتمترس في المواقف الفصائلية على حساب المصلحة الوطنية، وبعد لقاءات عديدة للمصالحة في مكة، واليمن، والقاهرة، والسنغال... فقد تبين أن السلطة و"حماس" قد جعلتا من التناقض بينهما تناقضاً رئيسياً، وجعلتا التناقض مع الإحتلال تناقضاً ثانوياً، أو تناقضاً ملغياً. هذا التموضع للتناقضات، الناتج عن مصالح وتجاذبات معينة، لا عن جهل في قراءة التناقضات الحقيقية للواقع وللصراع، إنما يسيء أشد الإساءة لقضيتنا الوطنية، ويطيل أمد شقاء الشعب الفلسطيني بدل أن يعمل على اختصاره ووضع حد له!
ربما يُعاقَب الشعب الفلسطيني برمته (كأي شعب) بالمعنى التاريخي، وبأثر رجعي، حين لا يمتلك بنية قوية، لانه لم يعرف كيف يختار وكيف يحاسِب، لم ينظر جيداً في المرآة، لم يلتفت إلى الشقوق في الوقت المناسب، ولم يحمل المبضع ويهرع إلى مواضع الفساد في الوقت الرخيص.
وهناك حقيقية مُرَّة هي: إن عدالة القضية لا تكفي لنصرتها، وأن بؤس القيادة وبؤس الوسائل يمكن أن "يبهدل" أعدل قضية!
وحتى يصح الصحيح، باختراق يأتي من البنية السائدة، أو من تفاعل بين المجالات والعناصر، داخلية وخارجية، ربما يحتاج الفلسطينيون إلى زمن ليس بالقصير، زمن من الخواء والتبديد والألم الممض، حتى يعبروا هذا الظلام.
هذا بالمعنى التاريخي، والحكمة تبعث على الحزن. أما الآن فإنه لألمٌ يهصرُ هصراً، أن يغدو الشعب الفلسطيني سفينة بلا قبطان، له "زعماء" ينجذبون إلى الكراسي.. لا إلى زيتون البلاد.
وبينما التشظي في الوضع الفلسطيني على أشده، ويستمر استهتار القيادة بمصالح شعبها، نجد إسرائيل تبني المزيد من المستوطنات، تسحب الأرض من تحت الفلسطينيين، وتقتل المزيد منهم، بصور وأساليب شتى.
وحتى يصح الصحيح، باختراق يأتي من البنية السائدة، أو من تفاعل بين المجالات والعناصر، داخلية وخارجية، ربما يحتاج الفلسطينيون إلى زمن ليس بالقصير، زمن من الخواء والتبديد والألم الممض، حتى يعبروا هذا الظلام.
هذا بالمعنى التاريخي، والحكمة تبعث على الحزن. أما الآن فإنه لألمٌ يهصرُ هصراً، أن يغدو الشعب الفلسطيني سفينة بلا قبطان، له "زعماء" ينجذبون إلى الكراسي.. لا إلى زيتون البلاد.
وبينما التشظي في الوضع الفلسطيني على أشده، ويستمر استهتار القيادة بمصالح شعبها، نجد إسرائيل تبني المزيد من المستوطنات، تسحب الأرض من تحت الفلسطينيين، وتقتل المزيد منهم، بصور وأساليب شتى.
في زمن مضى، كانت القضية الفلسطينية مركز ثقل وجاذبية للعالم العربي، وجسراً لأحلام المناضلين العرب، أما الآن فقد بهتت هذه القضية، وبهت العالم العربي، وانكسرت أحلام المناضلين. صحيح أن الوضع الفلسطيني والوضع العربي يتبادلان التأثير سلباً وإيجاباً، إلا أنه نوعٌ من التنصل أن يتم التذرع بالوضع العربي، أو العالمي، في مقاربة بؤس الحالة الفلسطينية، إذ أن البنية الداخلية تبقى هي الأساس، وعلى الفلسطينيين تنطبق جيداً الحكمة القائلة: القلاع لا تقتحم إلا من الداخل!